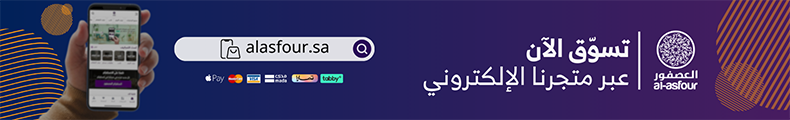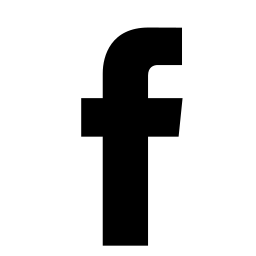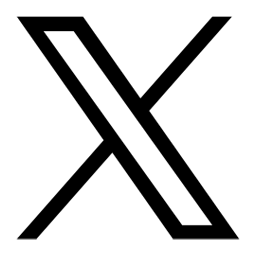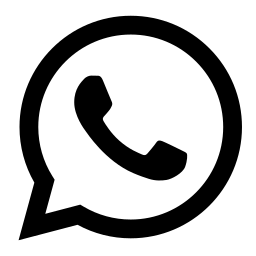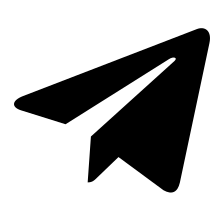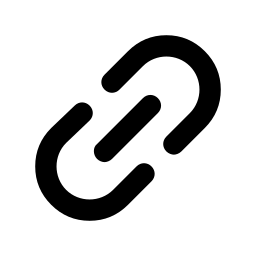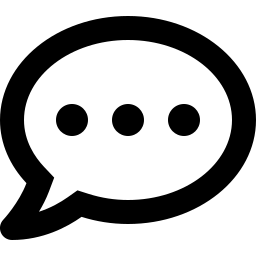دروس المحبة والكراهية
المحبة والكراهية طبيعتان متنافرتان. لكنهما إحدى الخواص الطبيعية في النفس البشرية، لا تنفك كل واحدة منهما تملك تاريخا عريقا من القصص والحكايات والشواهد والأمثلة التي تؤكد مرة بعد أخرى على حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها على الإطلاق: على المجتمعات أن تتعود على أن هاتين الطبيعتين لا يمكن انتزاعهما من قلوب الناس ومن مشاعرهم، فالمحبة تسري في عروق الناس كما هي الكراهية، وإن بدت المحبة عند البعض أكثر منها عند البعض الآخر، والكراهية تحتل مساحة في المشاعر عند البعض أكبر منها عند البعض الآخر. هذا هو ديدن سيرة العلاقات في كل المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ. على الرغم من وجود الأديان والرسل والأنبياء العظام وكبار المصلحين وجهود العلماء وتضحيات المفكرين والفلاسفة حيث ما زالت جميعها تناضل وتكافح من أجل نشر المحبة والعاطفة ونبذ الكراهية والعنف بين الناس كي تحقق حلمها للوصول إلى مجتمعات تعيش على المحبة والأمن والسلام. بيد أن مثل هذا الحلم هو أحد الأوهام الكبرى التي تلازم البشر في حياتهم. لكنه وهم لا غنى عنه؛ لأن إحدى أهم وظائفه الكبرى للإنسان ترسيخ الاستقرار النفسي وإعطاء الأمل في رؤية مستقبل الإنسانية بروح التفاؤل والكفاح.
لا أقول هذا الكلام كي أفتح بابا للتشاؤم واليأس من كل إصلاح أو أقلل من أهمية الدعوة إلى نشر المحبة بين الناس بكل الطرق والسبل، بل أجد من الضرورة بمكان فيما يخص بلداننا الخليجية كي نكون عقلانيين في علاقاتنا الاجتماعية على اختلاف تنوعنا الطائفي والقبلي والجغرافي هو استحضار القصص والأمثلة والشواهد التي تمثل إضاءات مشرفة في تاريخ المحبة من موروثنا، وكذلك مثلها استحضار القصص والشواهد التي تمثل معالم كبرى في تاريخ الكراهية ثم نبدأ بالتساؤل التالي: هل بالإمكان أن نجد زمنا يخلو من المحبة أو يخلو من الكراهية؟ الإجابة لا تتطلب كثيرا من التفكير، فمهما اشتهرت حقبة زمنية بشيوع المحبة بين ناسها لابد أن تكون الكراهية لها حظ من الوجود مهما تعددت أسباب هذه الكراهية، ولست هنا في محل نقاش هذه الأسباب، ولا حتى ضرب العديد من الأمثلة والقصص حول كلا التاريخين. لكني أقول هذا الكلام وأستدعيه حتى أصل إلى الخلاصة التالية: التعايش السلمي بين أطياف المجتمع المختلفة على أساس القناعة التامة بوجود الطبيعتين المتناقضتين في النفس الإنسانية، وتدعيم هذه القناعة بالشواهد التاريخية وبالتالي توظيفها واستثمارها سواء على مستوى التربية الأسرية أو التعليم المؤسسي هي إحدى الحلول التي ينبغي أخذ أهميتها بعين الاعتبار.