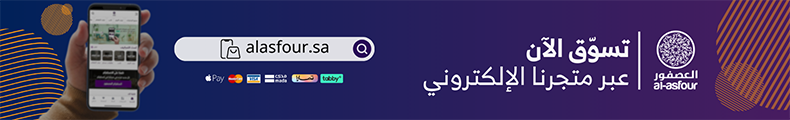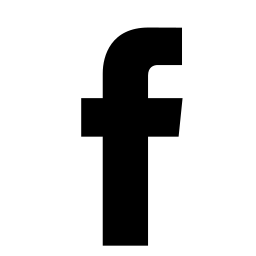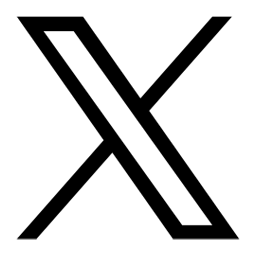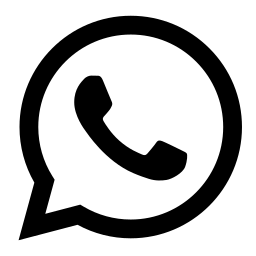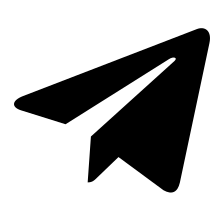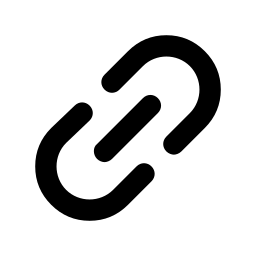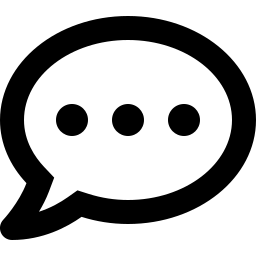إن كنت مشفقة علي دعيني «1»
لعل من القصائد الخالدة التي قيلت في الإمام الحسين  ، ولا يتحدث الناس عن شاعرها وناظمها ومبدعها، لكنهم يتحدثون عن القصيدة التي حملت أحد اشهر الأبيات التي قيلت في الامام الحسين وهو «إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خديني»..
، ولا يتحدث الناس عن شاعرها وناظمها ومبدعها، لكنهم يتحدثون عن القصيدة التي حملت أحد اشهر الأبيات التي قيلت في الامام الحسين وهو «إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خديني»..
هذه القصيدة لمبدعها الشيخ محسن ابو الحب الكبير، أحد أبرز شعراء الحسين، وهو في هذه القصيدة اعطى جملة من الإضافات إلى الصورة الشعرية، والتي اتسمت بالتالي حسب قراءة كاتب السطور
أولا: سهولة الألفاظ التي انطوت عليها القصيدة، فقلّما تجد في هذه القصيدة بيتا غير مفهوم، أو ينطوي على عبارات تحتاج الى معجم أو إلى شرح، أو تحتمل أكثر معنى، إلا فيما ندر.. ربما اعتبرت هذه السمة شيئا سلبيا عند البعض، خصوصا من محبّي الغموض تحت مسميات الجزالة والقوة والرصانة، والابتعاد عن السوقية والمباشرة والابتذال وما شابه ذلك، لكنها من ناحية اخرى تحمل في طياتها حالا إيجابية للغاية وتتمثل في أن قوة العبارة ليس في غموضها بل في صدقها، وهذا ما سوف نراه في قراءة القصيدة.
ثانيا: برزت براعة الشاعر، وقوة القصيدة في عدد من المواقع لعل أبرزها استنطاق الميت، فكان الإمام الحسين  يصف حاله بعد الموت، ويصف كيف قتل وكيف حرم من الماء وكيف سبيت حريمه.. وكان في البيت قد خاطب السيوف والرماح وطلب منها أن تأخذه وتسفك دمه من أجل الدين والمبدأ، حتى أنه في أحد الأبيات البس الحب ثوب الوقار، وشبه كربلاء المقدسة بروضة غناء أبطالها مثل ورود النسرين.
يصف حاله بعد الموت، ويصف كيف قتل وكيف حرم من الماء وكيف سبيت حريمه.. وكان في البيت قد خاطب السيوف والرماح وطلب منها أن تأخذه وتسفك دمه من أجل الدين والمبدأ، حتى أنه في أحد الأبيات البس الحب ثوب الوقار، وشبه كربلاء المقدسة بروضة غناء أبطالها مثل ورود النسرين.
ثالثا: ورغم البساطة والوضوح في القصيدة إلا أنه حفلت بجملة من الصور الفنية كالاستعارات والتشبيهات والمجازات وغير ذلك، فضلا عن التسلسل القصصي في بعض المواقع، مع احتفاظ كل بيت شعري بوحدته الفنية.
لنرى ما تقول القصيدة...
اللوحة الأولى «خطاب النفس»
في بداية القصيدة يناجي الشاعر نفسه، وينهاها عن مواصلة إغرائه بالحب، فهو من الأصل مصاب بالحب، لكن حبه من نوع آخر، فيخاطب نفسه ويدعوها لأن تتركه لهواه ولا تغريه بهوى وعشق آخر، فهو غارق في عشقه الخاص، الذي لن يتركه ولن يتنازل عنه، ويقرر بأن ثمة إغراء يتعرض له ويأخذ صفة اللوم والعتاب والتأنيب الذي يأتي من طرف يشفق عليه ويحبه، وهذا اشد وأصعب طرق وألوان الملام، لكنه يدعو نفسه بأنها إن كانت تحبه لتدعه إلى هواه الخاص.
ويقرّر في هذا الصدد أن الملام والعتاب الذي تعرّض له لو أنه استجاب له فسيكون غير مخلص وغير أمين لحبه وعشقه الخاص، فلو استجاب الى الملام فهو غير صادق وغير أمين لذلك،
ويقرر شاعرنا وبشيء من الغموض «في الفكرة لا في الألفاظ والعبارات»، بأن لديه حبا راسخا، لا احد يستطيع ان يزيله من قلبه، بل "كلما رام العواذل نقضة» لا يستطيعون لذلك سبيلا، أي انهم لم يتمكنوا من تحويل عشقه وهواه باتجاه آخر غير الذي اختاره.
ويمضى في شرح صورة هذا العشق، واضعا المتلقي أمام الصفات، دون التصريح بحقيقة الطرف المعشوق، فهذا الحب من صفاته أنه أخذ سمة العهد الذي لا ينقض، فمن ينقضه غادر، وليس من طبيعة العاشق الغدر.. كما أن هذا الحب ”جنون“ في واقعه، ”وقور“ في ظاهره، ويضع مثلا للحب وهو قيس ليلى، ويرى أنه نموذج للعشق المجنون، لكن حب شاعرنا هنا يختلف كثيرا عن حب قيس، فهذا الشاعر التحق بركب المجانين حينما وعا وكبر واشتد عوده، لكن حب شاعرنا ابتدأ معه قبل أن يفتح عينيه على الحياة، فقد ولد مجنونا بهذا الحب، فهل هناك حب يلد مع صاحبه؟!
ولم يتوقف سيل الوصف الرشيق لهذا الحب ليقرر أن حبه لو اطلعت عليه حمامات الدوح لتوقفت عن غنائها وعشقها، وراحت تنوح عليه وتؤبنه، بل إن هذا الحب بات مصدرا لتعاطف العديد منا الكائنات الحية
إن هذا العشق الخاص كبير، لدرجة يتم تشبيه معالمه بما يجري في الطبيعة، فالأنفاس متلاحقة كالبرق، والدموع غزيرة مثل المطر، ودقات القلب وحنين الأسى مثل الرعود.
ويزيد على ذلك بأن هذا الحب عميق في الشعور، لكنه وللغرابة غير موجه صوب النساء، فلا سعاد ولا رباب، ولا غيرهما، وليس صوب العيون السود ولا الشعر الغجري وإنما!!!!
وهكذا يأخذنا الشاعر من خلال 12 بيتا في اللوحة الأولى من صورة إلى أخرى، ومن لفتة إلى لفتة، ومن موقف غامض الى موقف آخر يفتح لنا بارقة أمل كي نتعرف على هذا الحب والعشق الذي هو اشد من حب قيس، ودقات القلب مثل الرعود، والدموع مثل المطر، واللفتات مثل البرق، به جنون ومع ذلك ليس به أي لمحة تجاه إمرأة فما هو هذا العشق؟
إنه عشق اهل بيت النبوة والرسالة، الذين الف شجونهم لما سمع بما جرى عليهم في كربلاء.
تلك هي اللوحة الأولى من هذا المشهد الدرامي المتسلسل بصورة منطقية جميلة، لا يشعر المتلقى بصعوبة الألفاظ، لكنه يصاب بالدهشة لعرض المضمون.
تقول اللوحة الأولى
إن كنت مشفقة علي دعيني **** ما بال لومك في الهوى يغريني
لا تحسبي أني للومك سامع **** إني إذا في الحب غير أمين
بيني وبين الحب عهد كلما **** رام العواذل نقضه تركوني
ألبسته ثوب الوقار تجملا **** كي لا تري بي حالة المجنون
إن جن خل العامرية يافعا **** فلقد جننت ولم يحن تكويني
لو أن صادحة الحمام تعقلت **** ما بي لأبدلت الغنا تأبيني
أو أن ”ضال المنحنى“ مستمطر **** دمعي لأبقاه بغير غصون
البرق أنفاسي إذا هي صعدت **** والغيث دمعي والرعود حنيني
قالوا: التجلد، قلت: ما هو مذهبي **** قالوا: التوجد، قلت: هذا ديني
لا في سعاد ولا رباب وإنما **** هو في البقايا من بني ياسين
الحب هذا لا كمن تاهت به **** في الغي سود ذوائب وعيون
لما سمعت بذكر يومهم الذي **** في كربلاء جرى ألفت شجوني
شاعرنا هنا يشعر بألفه وحنين مع الشجون والتوجد، فالحب قد تمكن منه من ناحية معنوية مثل تمسك العهد بالرجل الملتزم الخلوق، وقد بلغ هذا الحب حد الجنون، بل أن هذا الحب بات مثيرا لكل الخلائق
اللوحة الثانية «حقيقة الحب»:
في هذا المعرض تأتي اللوحة الثانية، التي يتخلى شاعرنا عن القول الحائر، ليوضح الحقيقة، حقيقة الحب الذي وقع فيه، والهوى الذي تمكن منه، فهذا الهوى بعد أن ذكر نقاط الاختلاف الذي يحمله مع كافة أنواع الحب الأخرى، نراه هنا يورد ما يتصف به من نقاط
به شيء من التعاطف، ضمن حلقات الصراع مع الخير والشر، فهنا الحب بمثابة انحياز للطرف المظلوم،
ان هذا العشق يلتقى مع انواع العشق الأخرى، من ناحية اللظى والأسى، بيد أنه لظاه يختلف عن لظى العاشقين، بنوعية هذا اللظي وذلك الأسى.
أن به جانب المأساة لدرجة لا تقارن معه نهشة التنين، بل حتى عذاب الآخرة يقل عن هذا العذاب.
إنها مأساة كربلاء التي تقول عنها هذه اللوحة:
غوثاه من ذكراك وقعة كربلا **** يا أم كل حزينة وحزين
ليس اللديغ سوى لديغك لا الذي **** أمسى يكابد نهشة التنين
وعسى اللديغ أصاب حينا راقيا **** إلا لديغك ما له من حين
حتى القيامة وهي دون عذابه **** بلظى همومك لا لظى سجين
لاقى الحسين بك المنون **** لاقيت فيك عن الحسين منوني
فنراه استخدم لفظة ”غوثاه“ ولم يستخدم لفظ استغيث، فمن المعروف ان ”استغيث“ فعل، و”غوثاه“ اسم فعل بمعنى استغيث، وهناك حوار طويل حول هذه المسألة اطلقوا عليه ”الخالفة“، فالتعبير ليس إسما وليس فعلا، وإنما هو اسم يؤدي دور الفعل، وقد استخدم في لغتنا العربية للتعبير عن مكنونات الذات، فهو أدق في التعبير من الفعل، والحال نفسه يجري حينما تقول: ”آه“ فهي أدق في التعبير من التعبير بفعل: ”اتوجع“، فالتعبير ب ”الخالفة“ أو ”اسم الفعل“ يكون أدق، وأكثر إثارة وإلفاتا للمتلقي، فحينما تستخدم هذا اللفظ يتساءل المتلقي بصورة لا إرادية عن سر الاستغاثة، لا بد أن أمرا كبيرا جرى نتيجة هذه الاستغاثة أو أن شيئا غير طبيعي جرى، ليأتي الجواب حاضرا وسريعا لا يطيل كثيرا على المتلقي حيث يقول بأن الاستغاثة هي من ذكرى مأساة عاشوراء، مصيبة كربلا فهي ”ام كل حزينة وحزين“،
بعد الاستغاثة يأتي الجواب متسلسلا، لأن الاستغاثة تقتضي سؤالا مضمرا في العبارة، يطلقه السامع، ويريد جوابا عليه فجاء كالتالي:
الاستغاثة جاءت بسبب معطيات وما تنطوي عليه كربلاء التي هي أم الحزن، وأم اهل الحزن، من ذكر وأنثى، وهنا إشارة أي إلى ان المصاب لم يشمل الرجال الذكور، بل حتى النساء الإناث.. واللفتة الفنية هنا هي جعل كربلاء أما، وما تعنيه كلمة الأم من معان أبرزها الاحتضان والاحتواء والانتماء والتربية، فالحزن والحزونون أنجبتهم كربلاء وربتهم وعطفت عليهم ورعتهم.. واللفتة الثانية أن الاستغاثة هنا ليس من الحدث نفسه، بل من ذكرى الحدث، فقد اراد الشاعر يقول بأنه يعيش حالة من الأسى تقتضى الاستغاثة وطلب المغيث لمجرد ذكرى هذا الحدث، ليقول للعالم كيف به لو عاصر الأحداث ورآها بأم عينه؟
ثم يمضى في وصف هذه الذكرى التي تقتضي الاستغاثة، لأن الاستغاثة تأتي جراء خطر معين داهم المستغيث، ويريد المعونة من الطرف الآخر، ويتمثل ذلك بأن ثمة ”لدغة“ طالته وهو على خطر الفناء والموت بسبب هذه اللدغة.. وهنا أيضا لمحة فنية تحملها هذه اللوحة الرائعة، وهي تشبيه بليغ بأن ذكرى عاشوراء بمثابة لدغة، وصاحبها المصاب باللدغة ”لديغ“ وهو اسم المفعول من فعل لدغ، واللدغ في معناه الحقيقي هي عضة الحية أو الثعبان أو العقرب من طرف خفي بحث نشب الناب في الضحية، فتأتي العبارة بموجب ذلك تحت تعبير الطعن والنيل من الخصم بالشر، وتأتي كذلك بمعنى الغدر والطعن.. وشاعرنا هنا يصف ذكرى عاشوراء بمثابة لدغة الدائمة التي لا يمكن أن تقارن بأي لدغة أخرى، بل لا يمكن ان تشبه بنهشة التنين، الذي يطلق على الثعبان العظيم، او الحوت، او التنين الحيوان الذي ورد في الكتب الأدبية الاسطورية التي تتحدث عن حيوان يجمع بين الزواحف «الافاعي»، والطيور الجارحة «النسر والصقر»، والحيوانات المفترسة «الأسد والنمر»، فتجد له مخالب أسد وذنب أفعى وأجنحة نسر، هذا الحيوان إذا طال أي شيء لا يمكن أن يجعله حيا، فلو طاله هذا الحيوان فيستحق أن يستغيث بصوت عال.
بناء على ذلك فمأساة كربلاء وذكراها لا يمكن أن يقارن ب ”نهشة التنين“، في إشارة إلى عظم الجريمة، وإلى تنوعها وتعدد وسائلها، فالتنين قد يأخذ ضحيته بناب الأسد أو بجناح النسر او بسم الأفعى.. وربما كان هناك دواء للدغة الثعبان إلا أن لدغة كربلاء فهي داء مستمر مادمنا على هذا الأرض، في هذه الدنيا الفانية، التي لا تعطي قيمة لشخص مثل الحسين بن علي عليهما السلام.. وربما أراد الشاعر القول بأن الجريمة في كربلاء جاءت متنوعة، بها القتل والحرق والنهب والغدر... الخ
ويمضي الشاعر في وصف المعاناة التي دفعته لأن يستغيث ليقول بأن المعاناة من كربلاء لا يمكن مقارنتها بأي معاناة أخرى حتى معاناة يوم القيامة، وهنا نتوقف عند نقطة هامة هنا، إذ قد يتصور القاريء لأول وهلة بأن الشاعر يستهين أو يستخف أو يستصغر مصيبة القيامة، وأهوالها، لكن الأمر ليس هكذا، وإنما قد يكون أراد الإشارة الى أن معاناة القيامة لما تأت بعد، بالتالي فلم نصل إلى تلك المعاناة، لكننا بمعاناتنا في كربلاء قد حدثت وما زلنا نعاني منها، والمعاناة في القيامة كما أظن من وجهة نظر الشاعر تهون وتهون وقد تنتهي لأننا في حضرة المولى الكريم الرحيم العطوف، الذي سبقت رحمته غضبه، فلا تقارن عقوبة من يغلب عفوه على غضبه ورحمته على سخطته بمعاناة من غلبت عليه اهواؤه وهم أهل الدنيا، الذي سفكوا دم الحسين وسبوا عياله وفعلوا ما فعلوا بجسده.. خاصة إذا علمنا بأن الشاعر ليس طارئا على الحياة الدينية فهو رجل متشرع من الأصل.. كما أنه أراد إلاشارة الى المعاناة المادية التي تطال المرء يوم القيامة، بينما هنا المعاناة معنوية قد جاءت من ”لظى الهموم“ لا من ”لظى السجين“، فهنا الفرق بين الأسى القادم من الهموم، والأسى القادم من الضرب والتعذيب.
وكل هذه المعاناة تمت في صورة خطاب موجه لذكرى كربلاء، وهذه صورة فنية أخرى، حيث جعل الشاعر الذكرى شخصا يملك جملة من المواصفات، فيخاطبه، ويتحدث عن جوره، فالذكرى هنا صارت «أما، وثعبانا»، لاقي الحسين بها منونه، والشاعر لاقى منونه عن الحسين ”لاقى الحسين بك المنون، لاقيت فيك عن الحسين منوني“