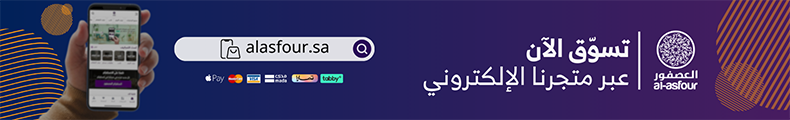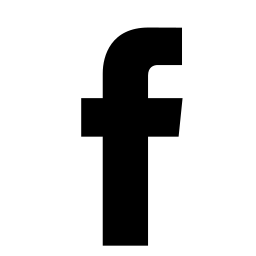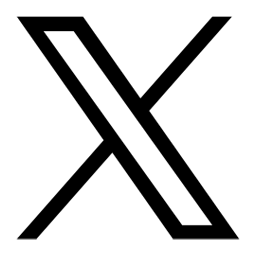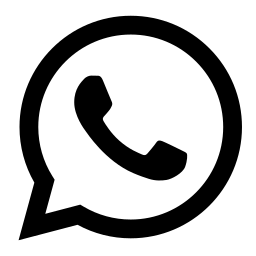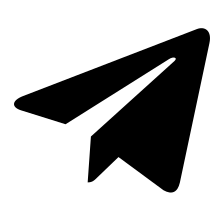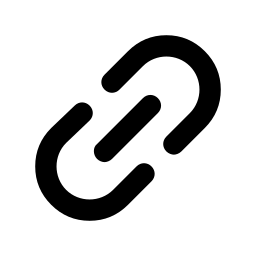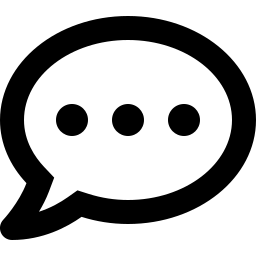فرانكنشتاين يعود في كل وقت!
في سنة 2016 حدثت المفاجأة عندما تغلب ”ألفاغو“، وهي آلة تعمل وفق شبكات عصبية ذات طبقات عميقة تحاكي دماغ الإنسان وجهازه العصبي، على خصمه ”لي سيدول“، بطل العالم في لعبة ”جو“، وذلك في المباراة التي أقيمت في سيول بكوريا الجنوبية في الثاني عشر من مارس 2016. وقد شاهد تلك المباراة مئات من المشجعين، وملايين من المشاهدين على شاشات التلفزيون. إن صورة الحزن التي ظهرت على وجه ”لي“، الذي خسر الجولة الثالثة من أصل خمس جولات، وبالتالي خسر المباراة، كانت تبدو كما لو أن الجنس البشري بأكمله قد فشل. الثقافة العالمية الكويتية، عدد يناير - فبراير 2019، ص95 «منقول بتصرف».
كلما تقدمت البشرية في المجالات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي، كلما بدأ الشك في صحة وسلامة هذا الطريق الذي يسلكه الإنسان والمؤدي - بالافتراض والأمل - إلى المستقبل المشرق يتسرب إلى العلماء والمفكرين والفلاسفة. فهذا الطريق ربما لن يكون محفوفاً بالأشجار الخضراء والثمار اليانعة، ولن يكون مكللاً بالأزهار والورود الذكية كما يعتقد كثير من الذين يستهلكون ويستمرؤون التقنية والتكنولوجيا. وهم، المستهلكون لتلك التقنية والتكنولوجيا، لا يستطيعون أن يشبعوا نهمهم منها، ولا أن يتوقفوا لحظة عن استهلاكها كي يفكروا في نتائج ذلك الاستهلاك، وذلك لأنها تتطور وتتنوع بقفزات كبيرة جداً جاعلة منهم يلهثون في اللحاق بها كي يظفروا بآخر تطوراتها، ولكن دون جدوى.
وقد تنوعت دواعي وبواعث هذا الشره وذلك النهم في استهلاك الوسائل التقنية. فتارة تكون الغاية هي البحث عن السهولة واليسر والخيارات التي عادة ما يبحث عنها المستهلك، وتارة يكون الاقتصاد والتقليل من التكلفة الإنتاجية التي لا ينفك المنتج في وضعها بعين الاعتبار. فالمستهلك مثلا، هام حباً في الأزرار التي ما إن يضغط على واحد منها ضغطة واحدة، إلا وقامت بعملية مكونة من خطوات عدة ومعقدة تحتاج إلى وقت وجهد كبيريْن بدون ذلك الزر. وهذا الزر صار الآن في كل حياتنا تقريباً، فجرس الباب وتشغيل السيارة وتفجير قنبلة وكتابة حرف تحولت كلها إلى ضغطة أزرار. فهذه الأزرار حولت الإنسان كما يقول ”جان بودريار“، فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، إلى ممثل أو متفرج فقط. فالأزرار تسهل أشكالاً من الإنسحاب من الحياة الإنسانية. فالطفل، مثلاً، أصبح بسببها لا يلعب مع الأطفال الآخرين، وإنما مع جهاز الكمبيوتر أو مع أطفالٍ يتوارون خلف جهاز الكمبيوتر.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور ليحل نظام التحكم بالإشارة أو بالصوت، كما في نظام siri التابع لشركة أبل، أو نظام التحكم باللمس محل الأزرار التقليدية التي بدأت تنسحب من الساحة رويدا رويداً. وكذلك الحال في الإنتاج وتقديم الخدمات أيضاً. فالربوتات البشرية مثلاً بدأت تستولي فعلاً على كثير من الوظائف في فنادق اليابان والولايات المتحدة، وذلك لأنها أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بالأيدي العاملة من البشر. فهي، الربوتات، تستطيع العمل على مدار أربع وعشرين ساعة في اليوم، مع عدم احتياجها للإجازات والأعذار المرضية. وكذلك فإنها تقوم بالأعمال المستقذرة والخطيرة والمملة دون تأفف أو ضجر أو شكوى. الحقيقة أن الربوتات والآلات، في كثير من الأحيان، تزيد من فعالية الإنسان نفسه أيضاً. ف ”لي سيدول“ الذي خسر في مباراته مع الآلة أو الروبوت البشري ”ألفاغو“ في لعبة ”جو“ قد تعلَّم ”استيراتيجيات ورؤى مختلفة. لقد تعمق في لعبته كإنسان، الأمر الذي جعله لم يستطع الإنتظار، وقام بتطبيق معرفته الجديدة في المباريات اللاحقة رفيعة المستوى، ليحقق ثمانية انتصارات متتالية.“ مجلة الثقافة العالمية الكويتية، عدد يناير - فبراير 2019. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيا الحديثة و”الأتمتة“ - عمل الآلة ذاتياً دون تدخل بشري - قد استحدثت وظائف جديدة ومختلفة ليقوم بها مثل الوظائف المتعلقة بالربوتات وتلك التكنولوجيا نفسها. بل إنها، الأتمتة، ضاعفت الحاجة للأيدي البشرية حتى في الوظائف الحالية، وذلك بسبب تزايد عمليات الطلب التي باتت سهلة وفي متناول اليد، كالطلب بالهاتف أو من خلال الإنترنت.
مع كل هذه التطورات والوثبات الطويلة في عالم التكنولوجيا ومع كل ما توفره من خدمات مريحة وفعالة لبني البشر، إلا أن الكثير وخاصة العلماء والفلاسفة والمنتجين، كما أشرنا، أصبح في حالة من التوجس التي تتضخم بشكل أكبر كلما زادت تلك التطورات كماً وكيفاً. فهذا الفيزيائي الإنجليزي الراحل ستيفن هوكينغ Steven Hawking صرح في خطاب له في سنة 2017 ب ”أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يعد الحدث الأسوء في تاريخ حضارتنا.“ وصرح قائلاً أيضاً، ”نحن لا ندري إن كنا سنحظى بمساعدة لا نهائية من الذكاء الاصطناعي، أو سيتم تجاهلنا وتهميشنا، أو حتى، من قبيل التخيل، ستقتلنا تلك الآلات“. وقد ذهب عالم الاجتماع ”وليم أوجبرن“ إلى أن التقنية هي العامل الأهم في إحداث التغير الاجتماعي. مجلة القافلة، عدد يوليو/أغسطس 2019. فبينما لا تزال فئة من الناس تستمتع بالحديث مع مقدم الخدمة في المطاعم والمقاهي وغيرها، فإن فئة ليست بالقليلة بدأت تتحول عن ذلك لتفضل التعامل مع الآلة والروبوت. فهي لا تريد أن تسمع من أي إنسان لا تعرفه جيداً ما لا تحبه أو ما لا يهمها. كذلك، فإنها لا تريد أن تتحدث هي إليه، عندما يبدؤها هو بالحديث، بما تظن أنه ليس من شأنه ولا يعنيه. فتجد أن الكثير من هذه الفئة اكتفى بالطلب من خلال التطبيقات من خلال جهازه أو هاتفه كما في بعض المطاعم، مكدونادز مثلاً، والمقاهي، ستاربكس مثلاً، وحتى متاجر الكتب أيضاً من مثل أمازون وغيرها. فالسرعة في الحصول على الطلب هي الأهم الآن. بل إن بعض الناس بات يفضِّل الحديث إلى الآلة أو إلى إنسان من خلال الآلة، كما في مواقع ”الشات“، عن الحديث إلى الإنسان بشكل مباشر. وقد تحدث إليَّ بعض ممن يعملون في المصانع والمعامل بأنهم فعلاً يفضلون أن يكون شريكهم في العمل آلةً أو روبوتاً، فهي أصدق وأكثر كفاءة وإخلاصاً وإتقاناً في العمل، ولا تحمل في نفسها ما يجعلها تفكر يوماً في النيل مني أو إلحاق الضرر بي.
وفي كل مرة تعيد فيها الإنسانية النظر في مسألة التكنولوجيا وتطوراتها ونتائجها السلبية والإيجابية، تظهر أمام أعينها رواية الكاتبة الإنجليزية ماري شيلي «1797 - 1851» ”فرانكنشتاين“ المنشورة في سنة 1818 والتي تنتهي بتمرد المخلوق «الوحش» وقتله للعالِم الذي صنعه. فرغم أن تلك الرواية هي من نسج الخيال، إلا أن المخاوف من تحول ذلك إلى حقيقة ماثلة أمامنا في المستقبل القريب أخذت تتضخم وتنمو، كما أشرنا، بشكل ملفت للنظر. فالتطور الكبير في صناعة الربوتات، وتطور ذكائها العملياتي، قد يؤدي إلى تمردها على الإنسان ”في نهاية الأمر. ورغم مرور ما يقارب مائتين سنة على نشر تلك الرواية، إلا أنها لا تزال تطل علينا بين الحين والآخر لتطرح علينا سؤالاً ملحاً نحتاج أن نتحقق من إجابته أو على الأقل مناقشته، قبل أن نخطو خطوة في أي اتجاه. فهذا السؤال الفلسفي الوجودي المتجدد“ هل نحن باختراعاتنا وإبداعاتنا الصناعية والتكنولوجية في المسار الصحيح المؤدي إلى النعيم والسعادة للإنسانية، أم أننا في الطريق الخاطئ المؤدي إلى شقائنا وحتفنا؟ " يحتم على من يهمه مستقبل الإنسان أن يأخذه بعين الاعتبار في كل وقت وفي كل حين. وهذا ما تطرحه تلك الرواية في جوهرها.