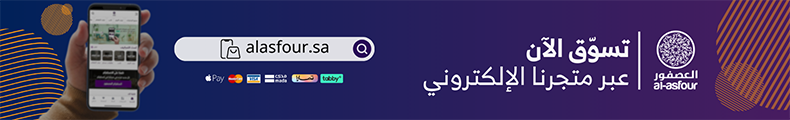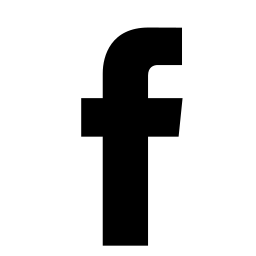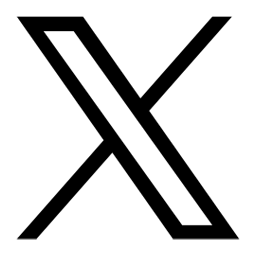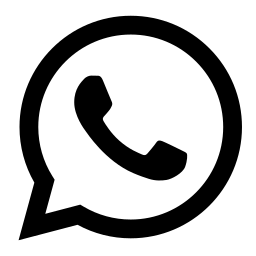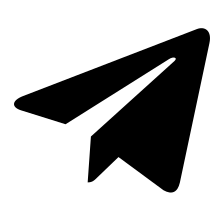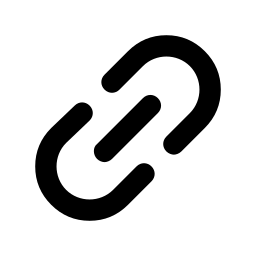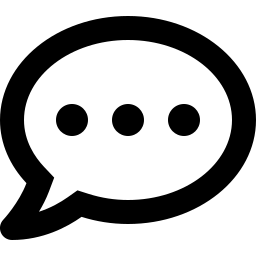تنبؤات درامية أم سينما متواطئة «35»
وسط غابات النخيل تتراقص الحرائق على مد البصر، برتقاليات محمرة تتموج حمم لاهبة، اشتعالات تتأجج ضرامة وسعيرا، نار الله الموقدة تأكل العشب والورد، والسامقات تصارع الموت، سعف غض يذوي رمادا، تتشظى الأغصان والجذوع جمر، ثمر يتطاير شهبا، سحب سوداء تغطي السماء والضوء يعلن الحداد، يضرب البحر فتفور نوافير ماء، طقس جهنمي بقنابل النابالم ترسلها طائرات الحرية، وفي لمح البصر تباد جنات النعيم احتراقا، حقول المانجو والأرز والشاي والقهوة، أضحت عروش زرع خاوية، أنفاس بلا مأوى، والقوت قتال، دم الأرض يقاوم، الأثر يقاوم، التاريخ يقاوم، التضاريس تقاوم، جن جنون المسعورين، والمعارك من تحت أرجلهم زلزال، أدركوا بعد 20 عاما أن محرقة الموت بلا طائل، فارتد الجناة على أعقابهم يجرجرون أذيال الخيبة..
نهضت فيتنام كطائر الفينيق من ركام الرماد، شعب سطر الكفاح بدمه وأصبح أنشودة الملايين، الراية الحمراء خفافة في الشمال والجنوب والوسط، وجوه تتبسم للنجمة الذهبية وجباه مشرئبة بأكاليل النصر.
مشاهد رعب مروعة وثقتها عيون الأخبار، ورصدتها وكلات الأنباء المحايدة من أرض فيتنام الجريحة والظافرة بالعزة والكرامة، بينما السينما في أوج المعارك وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أطلقت روح العنان للدراما. واقتنص المخرجون والكتاب مشهدا وألف مشهد في صناعة العديد من الأفلام بأسماء رنانة وعناوين نصر مخادعة بين الوهم وأنصاف الحقيقة، كل ينافس الآخر لإظهار الوجه القبيح للحرب سواء باستعراض قوة أو دفاع مستميت.
ترجمات هلاك وفزع، قدمها فيلم ”القيامة الآن“ بمشاهد دامية، فمن يشاهد معركة الفيلم يرى الموت كيف يصطاد الأبرياء كالعصافير.
فيلم وإن اختلفت التفسيرات والتأويلات حوله فهو أبرز الأفلام الحربية حضورا في تاريخ السينما، وبحسب المعركة التي قدمها المخرج ”فرانسيس كوبولا“ فهي إعجاز درامي قل نظيرها في عالم الدراما.
وقبل الفيلم وبعده قدمت أفلام ومسلسلات تصور معارك طاحنة، بذات النسق والطرح، وبعيدا عن المقارنات بينه وعديد الأفلام وإن كان كلهم في الهوى غرب، فإن هذا الفيلم يتميز بضراوة المعركة وشراسة القصف، لمشهد طوله 17 دقيقة يحبس الأنفاس، قمة في الإخراج وحرفية عالية في التصوير بشكل يرسل الرعب في نفس المشاهد، لقطات حرب تعلق في الذاكرة وان طال الزمن لا تنسى لكن جحيم الواقع لم يزل يؤرق من قادوا المعارك بخسران مبين، الفيلم في عمومه متعة بصرية يفوق الوصف برغم مرور 43 عاما على إنجازه، حينها التقنية الحاسوبية لم تقتحم بعد مجال السينما مثل ما هو حاصل الآن، حيث يتم توظيف الكمبيوتر في الخدع البصرية.
إن فيلم ”القيامة الآن“ مبهر على جميع المستويات ومثير للجدل وله ماله وعليه ما عليه، ويكمن إبهاره في روعة تصوير أحداثه، ومن خلاله تحصل المصور على جائزة الأوسكار.
إنه المصور الإيطالي ”فيتوريو ستورارو“ هذا المصور السينمائي عيناه ليست ككل العيون، هو واحد من أفضل عشرة مصورين في تاريخ السينما في العالم، حاصل على 50 جائزة دولية ثلاثة منها جوائز أوسكار، عن الأفلام التالية:
1 - القيامة الآن 1979
2 - الحمر ”ريدز“ 1981
3 - الإمبراطور الأخير 1987
ومن خلال الفيلم الأخير تعرف كاتب السطور لأول مرة على المصور ”ستورارو“ من خلال الصحف والمجلات وبرامج التلفزيون، بين عامي 87 و88 بعد تغطية إعلامية مستحقة حول فيلم ”الإمبراطور الأخير“ الذي إخراجه المبدع الإيطالي ”برناردو البرتولوتشي وهو صديق عمر ”ستورارو“.
وقد حصل الفيلم على 9 جوائز أوسكار اثنان منها للمخرج والمصور.
إنه فيلم يعد ملحمة فنية تاريخية، وهي قصة حياة آخر أباطرة الصين، ممتلئ بالأحداث الهامة والتحولات المفاجئة والتغيرات العاصفة، ومفعم بالنستولوجيا والشاعرية والجمال، التي تقف ورائه عين ”ستورارو“ الخلاقة.
إنه مصور متفرد عازف على فلسفة ودلالة اللون والضوء، من خلال فهمه ومعرفته الواسعة بتاريخ الفن والفنون عامة، مشبع بعوالم اللوحات لفنون عصر النهضة الإيطالية ولاسيما دراما الضوء في لوحات ابن وطنه ”كارافاجيو“ الذي استمد منه رمزية الضوء والظل، في كثير من أعماله السينمائية، وتتجلى فلسفة الفن التشكيلي بكل معانيها في براعة التقاطاته المدهشة، فهو عاشق للوحات الفنية وكل مدارس الفن وكذلك عالم الأدب والموسيقى والفلسفة والرواية، اطلاع واسع بمعرفة عميقة للإبداعات الإنسانية التي انعكست على ذائقته الفنية والمترجمة إحساسا معبرا وفاتنا في معظم منجزاته السينمائية.
ونرى إحدى لقطات الغابة من فيلم ”القيامة الآن“ حضرت لوحات الفنان ”هنري روسو“، وكذا لوحات عمالقة وأساطين الفن، ومن هنا تعددت وتنوعت التقاطاته في ذات الفيلم وغيره من الأفلام التي أبدع في تصويرها.
عينه شاخصة لتحولات أضواء النهار المختلفة باستثمار حاذق لرسم المشهد، ويمازج بين الضوء الطبيعي والمركب «الصناعي»، مذهل في خلق طقوس ظلام الليل، والأماكن المعتمة وتسليط الإضاءات عليها كأنها إضاءات كنسية، ضوء ماطرة على الرموز الدينية لتنضح بنورايتها الإيمانية، بارع في تجميل الفضاءات المفتوحة بإدخال الأبخرة والأدخنة الملونة المرسلة في ثنايا المشهد، فكل لون عنده معنى ودلالة، يضفي شاعرية على الشخوص، وأخرى تعبيرية على الوجوه وما تخبئة النفوس، يستثمر سقوط المطر والتماع العناصر برهافة وادعة، وإحساس رومانسي مفعم بالذوبان في اللقطات الحميمية، ويترجم انعكاسات الماء بألق فاتن، ويسمعنا ارتجاج الأرض من صخب وضجيج غبار المعارك.
إن متعة التقاطات تصوير ”القيامة الآن“ تحرض العين للمشاهدة ثانية وثالثة وهذا ما فعله كاتب السطور ليس لمعرفة أحداث القصة فقط، بل من أجل الاستمتاع باللقطات الآسرة جمالا، والذي تعتبر بمثابة معرض فني مفعم بالقيم الفنية والجمالية المعبرة بدلالات اللون والضوء على أعلى مستوى من الدهشة البصرية.
مصور مبتكر ”يستخدم تارة الألوان المتعارضة لتحديد شخوصه وخلق نوع من التوافق الخفي بين الظلال اللونية والعواطف الشخصية منتجا بذلك تضادا مدهشا بين واقعية الحدث والواقعية المفرطة للصورة“.
وقد حدد ”ستورارو“ نهجه الفني وجوهر أعماله بكلمات معبرة: ”إن الصراع بين الليل والنهار، بين الظلال والضياء، بين الأبيض والأسود، بين التكنولوجيا والطاقة هو الذي يتحكم بي وبجوهر عملي دائما“.
ويرى أن السينما تقتات بالفنون الأخرى كالأدب والرسم والموسيقى والمعمار والفلسفة وسواها، وقد أصدر كتب كثيرة من ضمنها ”الكتابة بالضوء“ الذي وضع فيه خبرته السينمائية ومعرفته بالفلاسفة والرسامين والعلماء.
ويؤكد ”ستورارو“ عن سر اكتشافه للقيمة الرمزية للون، المعنى، الفلسفة، فلسفة الضوء. ”لقد تعلمت أن كل لون بوسعه أن يغير من عمليات البناء والهدم فينا، يغير ضغط دمنا، لقد أدركت فلسفة اللون، أدركت أن كل لون بوسعه أن يغير أجسادنا ومواقفنا“ ويقدم رؤياه لكل مصور، لا يفترض بالمصور السينمائي أن يكون ممثلا أو شاعرا أو رساما، لكنه بحاجة أن يعرف شيئا عن كل أشكال الإبداع هذه“.
حينما نتأمل أعمال هذا المبدع بعمق الذي استطاع تفكيك أطياف الضوء نجد بأنه يملك عين رسام ماهر وعقل فنان عملاق.
هذا المبدع منحاز للرؤية السينمائية الأوروبية أكثر من الأمريكية الذي يشبهها بمثابة ”مصنع كبير ينتج أفلاما يتماهى أحدها عن الآخر، وبذات الهدف وبذات البنية، بينما في أوروبا بحث مستمر عن الجانب البصري الذي يدعم قصة الفيلم، أن تجرب أن تعطي كل فيلم نظرة أو طريقة تعبير محددة“، وهذا ما قام به حينما صور فيلما ثلاثيا عن حياة نبينا ﷺ بعنوان ”محمد رسول الله“ للمخرج الإيراني ماجد مجيدي، مشروع متميز وفريد في أبعاده الإنسانية.
وتحدث ستورارو لمجلة ”المصور الأمريكي“ عن هذه التجربة ”محمد لم يكن رسول الله فحسب، بل رسول سلام أيضا، وهذا الأمر مهم جدا“.
كم هي الأفلام التي تفيض متعة بصرية ورؤية فكرية، للمصور ”ستورارو“ وغيره من المبدعين الكبار، فالذائقة حبلى برؤية الفنان المصور الذي يدهش الفكر قبل النظر، ويأسر جميع الحواس.
وبنظرة عامة هل كانت الأفلام الحربية الأمريكية أفلام محبة وسلام؟ أم تحريض مبطن بأن تحقيق السلام لا يتم إلا باستخدام مفرط للقوة؟ وأي سلام يأتي دائما بفرض القوة سواء حربا أو حصارا، والأفلام هي ترجمان لعقلية الساسة المستعينين بمقولة الإمبراطور الروماني ”سور هادريان“ الذي يعتبر رمزا لسياسة القوة.
إن تخمة دراما أفلام الحروب الأمريكية، حرضت الذاكرة للعودة لأوائل السبعينيات الميلادية حيث شهدت مع أبناء جيلي مسلسل تلفزيوني عن الحرب العالمية الثانية من خلال شاشة تلفزيون أرامكو «الظهران»، الذي كان يقدم حلقة كل ليلة ثلاثاء تحت عنوان «جحيم المعركة» يظهر فيها قدرات جنود الحلفاء وانتصاراتهم وبالأخص الأمريكان، والذي علق في البال ونحن منغمسون في إحدى حلقات المسلسل من خلال جهاز تلفزيوني متوسط الحجم «أسود وأبيض» وذلك في إحدى غرف نادي الهدى بتاروت الواقع في الدور الأول لمبنى عمارة العماني المطلة على السوق.
وبينما نحن نصفق لبسالة القوات الأمريكية! نسمع نقدا لاذعا لإحدى المشاهد، من شخص أوعى منا وأكبر سنا يدعى ”أبو مدين الصغير“ يقول ”لهدرجة الجنود الألمان أغبياء، تضحكوا على من بهالتمثيل العبيط“! حينها ازعجنا الكلام، ورد عليه الأخ حسين قيس الذي يتصف بخفة الدم ”اي تمفيل يابومدين هذا موتمفيل هذا كله حقيقة، ماتشوف الجنود كيف يطايروا من القنابل والايادي والرجايل والرؤوس مقطعة ومنتفه ومرمية على الأرض ومعلقة فوق اغصان الشجر“ كلام حسين لم يكن هزلا بل جادا ومعتقدا بأنه مايراه بالفعل واقعا، والمثير بأن الحلقات جعلتنا نمقت كل ماهو ألماني بخوذاتهم المميزة، فقد صورتهم الدراما في منتهى السادية وبأنهم قساة وعديمي الرحمة، يقتلون حتى الأسرى، ويغتصبون النساء، ويعدمون الأطفال، وكل الشرور الصقت بهم، بينما جنود الامريكان العكس من ذلك مثاليون لابعد حد، وهذه الرؤية ممتدة ليس في مسلسل ”جحيم المعركة“ بل في اعمال درامية كثيرة ومن يطالع افلام الحرب العالمية الثانية السينمائية يرى العجب العجاب من الحط من جنود الالمان وكل دول المحور المنهزمة.
عندما كبرنا أدركنا ما كان يقوله أبو مدين، فكل أفلام الحروب ”بروبغندا“ بامتياز تخدم مصالح الدول بميزانيات ضخمة مكلفة في عمليات الإنتاج لكن الغاية عندهم أكبر من أي كلفة، وان رأيت فيلما فيه وجهة نظر منصفة بعض الشيء لكنها تظل مسحة تجميلية لترويج الفيلم، وقيل عنهم ”صناع السينما في هوليود يضعون في أفلامهم سما وعسلا“ ودائما المنتصر يكتب التاريخ على هواه، لكن سينما هوليوود تحديدا سواء في النصر أو الهزيمة دوما أمريكا منتصرة والجندي الأمريكي سوبرمان الزمان والمكان!.