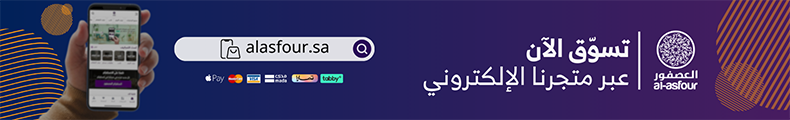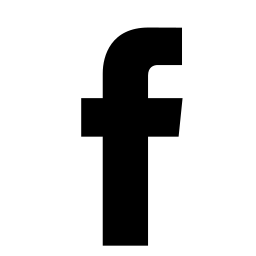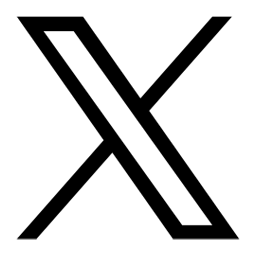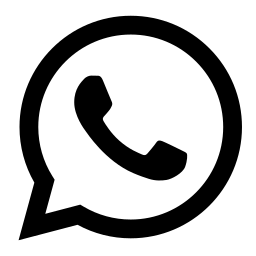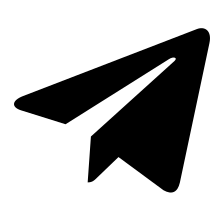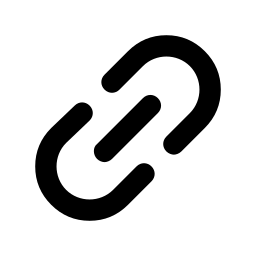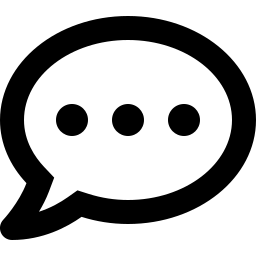في التثقيف الذاتي
إذا كانت العملية التعليمية تُخرج فرداً متخصصاً في مجال معين، أو مهنة معينة، أو منحصراً في نوع واحد من أنواع العلوم، وتؤهله لنيل شهادة تخوله الحصول على وظيفة يعمل بها في مجال تخصصه، يفيد بها المجتمع الذي ينتمي إليه، فإن التربية الثقافية تشكل شخصية الفرد، وتنير دربه وتزوده بالزاد المعرفي، وتؤهله للحصول على قدر كاف من الفهم والوعي ليكون قادراً على التعامل مع الظواهر المحيطة به، والبشر من حوله، والقدرة على حل المشكلات التي تواجهه، وممارسة دوره في كافة دروب الحياة بكفاءة واقتدار.
ولا شك أن ”تأثير الثقافة في الشخصية أمر ملموس لا يحتاج إلى برهنة أو تدليل، فالمثقف يكون منظم الذهن عميق التفكير واسع الأفق على وعي بما يدور حوله من أحداث وقضايا، كما يكون في الغالب قادراً على التعبير عن آرائه بأسلوب واضح لا التواء فيه ولا تعقيد. أما غير المثقف فإنه يكون ضحل الأفكار ضيق الأفق ومهلهل الأسلوب غالباً. ولكي يجمع القارئ بين الزاد الفكري والمهارة التعبيرية يجب عليه أن ينوع قراءاته فيقرأ كتباً علمية وكتباً أدبية محاولاً حفظ الجيد من الشعر الجميل والنثر البليغ ليملك الأداة المعبرة عن أفكاره“. «[1]
واليوم ليس المطلوب فقط دعوة الصغار وطلاب المدارس والمتعلمين والدارسين في كافة مراحل ومستويات التعليم إلى التثقف والتزود بالمعارف من خارج المقررات الدراسية، وإنما الدعوة موجهه للجميع، ومهما ارتفعت، أو تدنت، مستويات تعليمهم، وكلٌ حسب قدراته وإمكانياته ووقته، من أجل بذل الجهد لرفع مستوى قدراتهم العلمية وتحصيلهم الثقافي، من خلال ممارسة التثقيف الذاتي والتعلم وكسب المعارف.
ولئن فرضت الظروف على أحد ما ألا يستكمل تعليمه الأكاديمي، غير أنه من خلال التثقيف الذاتي يمكنه تنمية ثقافته، وتعويض ما فاته، وتحصيل العلوم، وكسب المعارف، من دون دخول جامعات أو معاهد. فكم هم هؤلاء الذين لم تتح لهم الظروف أن يكونوا من بين خريجي المعاهد والجامعات، أو أنهم لم يتلقوا التعليم الأكاديمي الكافي، أو لم يكملوا حتى مرحلة الدراسة الابتدائية. إلا أن ذلك لم يشكل معوقاً أمام البروز الذي أوصل البعض منهم إلى القمم في المجال الذي اختاروه لأنفسهم، بسبب الإصرار على النجاح والتفوق، والمثابرة على اكتساب المعارف بالتثقيف الذاتي، فضلاً عن اكتساب الخبرة من تجارب الحياة، وهي أسباب لعبت دوراً أساسياً فيما وصل إليه البعض من مكانة في تاريخ أوطانهم، أو في تاريخ الإنسانية عامة.
ويتجلى مما سبق أهمية كسب الوعي والثقافة والمعرفة من خلال التثقيف الذاتي، بحيث تتحول القراءة إلى عادة حياتية تلازم الجميع مدى العمر. فالقراءة ليست وقفاً على مرحلة معينة ولا سن معين. إذ أن الإنسان تلميذ دائم. وطالب العلم نهم لا يشبع مهما طال به العمر، كما لا يرى في نفسه الكمال والتمام مهما بلغ من الثقافة، بل يرى نفسه ما يزال طالباً يدرس ويتعلم. وحسبنا في هذا السياق القول المعروف ”اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد“. فالتحصيل المعرفي عملية مستمرة لا تعرف التوقف، وتتغذى دائماً بالجديد والمفيد. فالثقافة والمعرفة بحر واسع لا تنضب مهما غُرف منه. والعلم سيلٌ جارٍ لا يمكن أن يتوقف عند حدود، أو يجف أمام باب.
وعليه فإن التثقيف الذاتي هو سبيل الجميع للتعلم مدى الحياة، وما على الإنسان إلا تطوير معارفه بالمزيد من المتابعة والاطلاع والبحث عن الجديد. وكلما استطاع الإنسان بذل جهده في تثقيف ذاته، وسعى إلى اكتساب أكبر قدر من الثقافة الرفيعة والجادة، نمت شخصيته وتطورت، وانعكس ذلك إيجاباً على حياته وسلوكه، وأدى إلى تطوير نوعية حياته والارتقاء بها. وما على الإنسان من أجل تحقيق هذه الجودة الثقافية، إلا استثمار حياته وعمره ووقته مجتهداً في تنمية ملكاته وقدراته، والعمل على كسب المعارف النوعية التي تدعم تطوره، وتحصنه فكرياً وثقافياً في ظل التنافس والصراع السائد بين الأفكار في هذا العالم.
إن الثقافة ركن هام وأساسي من أركان بناء الشخصية الإنسانية، بل هي حجر الزاوية في تكوينها ونمائها. فهي تعرفه على نفسه أكثر وأكثر، وتنضج شخصيته وتصقل نفسيته ومواهبه ومهاراته، وتفتح مغاليق ذهنه على كنوز من الخبرات والتجارب الإنسانية المتنوعة، وتقوي شعوره بالقيم والمثل الرفيعة، وتزيد من قدرته على التمييز بين ما هو شر وما هو خير، وبين ما هو خطأ وما هو صواب، خصوصاً في زمننا هذا الذي تتنازعنا فيه المغريات والأفكار من كل حدب وصوب.
وغني عن القول بأن الارتقاء بأي مجتمع وتطوره، ومجاراة تغيرات هذا العالم ومستجداته، والتأقلم معها ومسايرتها، يتطلب الرقي بأفراده، وتطوير قدراتهم المعرفية. ومع أن الثقافة هي أداة التطور والرقي، غير أنه من دون أفراد ذوي قدرات ثقافية نوعية، وخلفيات خُلقية رفيعة، يصعب منافسة المجتمعات الأخرى ومجاراة تطورها. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال نشر الوعي بين الناس، وتطوير مستوى ثقافتهم، ليكونوا قادرين على استيعاب ثقافات الآخرين ومنافستهم، حتى يكونوا مؤهلين للاختيار السليم والحسن من بين الأفكار والثقافات المتنافسة أمامهم، وانتقاء الأفضل والأجود منها، وبما يتناسب والارتقاء بشخصية كل فرد وأفكاره وحياته، وحياة المجتمع الذي يعيش فيه.
إن مجاراة ركب التطور والتقدم الحادث في عالم اليوم يستدعي تمكين الإنسان من التعرف على الحضارة الحديثة والإلمام بها وتعلمها والتسلح بأدواتها. ولن يكون ذلك ممكناً إلا بتشجيع الاهتمام بثقافة المطالعة والقراءة، والتأسيس القوي والمتين لهذه الثقافة، بحيث تتحول القراءة إلى مشروع استراتيجي أصيل يهدف إلى تطوير مستوى الفكر والتفكير، وليس مجرد مظهر وجاهي خارجي، أو عادة روتينية مفرغة من أي محتوى أصيل. فقراءة الكتب تعد رافداً مهماً من روافد الثقافة والعلم والمعرفة، والمعين الذي لا ينضب، والمنهل الذي لا يجف.
ولا نخطئ القول حين نصف عملية التثقيف الذاتي بأنها في الأساس مهمة فردية، ومسؤولية ذاتية، قبل أن تكون ذات بعد جماعي. بمعنى أن الفرد مسؤول أولاً عن تثقيف نفسه بنفسه، والاشتغال على بناء ذاته بإصرار وعزيمة وإرادة لا تلين، وأن تكون لديه الرغبة في زيادة وعيه وثقافته ومعارفه، وأن يجعل الكتاب رفيقه وأنيسه، وأن يلزم نفسه بالقراءة والتعود عليها، مع تخصيص الأوقات المناسبة لذلك، وأن يكرس وقته للقراءة الواعية النافعة، والاطلاع الواسع والمستديم. مع أهمية تفادي كافة الأشياء التي تشتت انتباهه، كالإنترنت، والهاتف، وجهاز الكمبيوتر.
وعلى هذا الأساس من المفيد أن يضع كل فرد لنفسه برنامج للقراءة واعٍ وهادف وممنهج ومتناسب مع قدراته وإمكانياته، وألا يكتفي بحد معين من الاطلاع والمعرفة ثم التوقف بعد حين، لأن المعرفة تحتاج إلى وقود معرفي، سواء من أجل تنشيطها، أو من أجل تطويرها، وهذا يعني الاستمرار والاستزادة في اكتساب المعارف والعلوم مهما طال العمر. وحتى يحفز الإنسان نفسه على مواصلة تحصيله المعرفي عليه إحاطة نفسه بالأجواء المشجعة على القراءة، مع مصاحبة المهتمين بهذا الشأن.
خلاصة القول هي أن ”القراءة المستمرة والجادة والهادفة تعد أهم الوسائل الثقافية، وأهم أدوات التثقيف، وأهم روافد الثقافة والتنمية الفكرية، مع الاختيار الواعي لنوعية المقروء فرزاً وانتقاء، والتعمق في المقروء، وتجنب السطحية والانفعالية والاستعراضية، فيشكل الإنسان أدواته الثقافية وأسلوبه وفكره ومفرداته التي ترافقه في جميع مناحي حياته، وبغض النظر عن اختصاصه العلمي والعملي، فينطلق في مجالات الإبداع والابتكار، ويكسر مراحل الجمود والروتين، وينمي الثقة بالنفس والقدرة على الفعل الدائم، ويصنع شخصيته ابتداء من مفرداته، وانتهاء بكم المعرفة الراسخ في ذاكرته القريبة والبعيدة، ولتكون هذه الشخصية ذات نفع في بناء مجتمعها وتطوير قدراته“. [2]
لقد سبقت الإشارة إلى أن عملية التثقيف الذاتي هي في الأساس جهد فردي ومسؤولية ذاتية، غير أن هذا الأمر لا يعفي المؤسسات المعنية بالتنمية الثقافية من وضع الخطط والبرامج التي تنهض بالفرد، وتنتقي أفضل الأنشطة الملائمة التي ترتقي بثقافته، من خلال تكوين الأطر المناسبة، كنوادي القراءة ومنتديات الحوار، أو تنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل التي تهتم بقراءة الكتب، والتعريف بها، والبحث في مضامينها، ونقد محتوياتها، بحيث تكون هذه الأطر بمثابة الدليل المرشد للقراء عن كل ما يتعلق بشأن القراءة، وهو ما من شأنه تحبيب الناس في القراءة، والمساعدة على تنمية ثقافة القراءة على أوسع نطاق.
في الأخير يبقى الرهان على أن تتحول القراءة إلى عادة اجتماعيّة، وسلوك ثقافي، وقيمة رفيعة وخلاقة، لها مكانتها واعتبارها بين كل أفرد المجتمع، إذ لا يكفي أن تظل مجرّد نشاط يهتم به أفراد محدودين، أو عملاً نخبوياً يختص بفئة قليلة من الناس، بل المأمول أن تتحول إلى عادة يوميّة ملحّة، ونشاط يمارسه الجميع من دون استثناء. فالقراءة ليست مجرّد تَرف ووجاهة، بل هي حاجة أساسيّة، وضرورة ثقافيّة ووجوديّة، من أجل بناء مجتمع ينهض بقدرات كل أفراده.