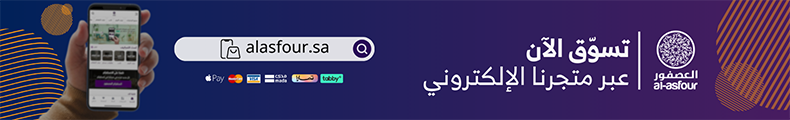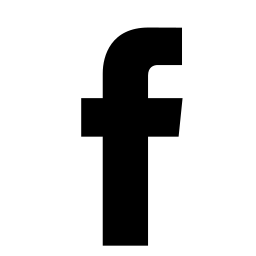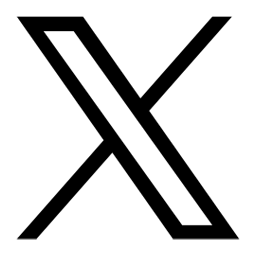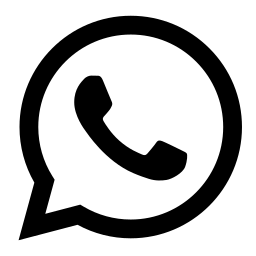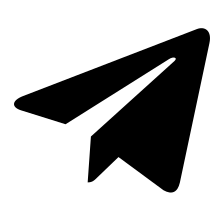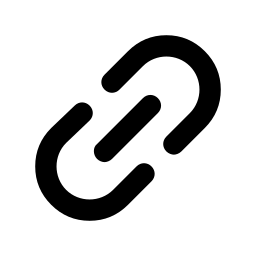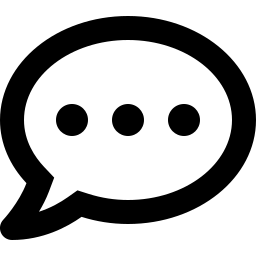لأكثر من 90 عاما من المعاناة والعطاء:
”ابن الشيخ“ الخنيزي يحلّق شعرا ببصيرة نافذة وإرادة لا تعرف المستحيل
حين تلتقيه يأسرك بحسن أخلاقه، ويأخذك بتواضعه الجم، ويلفت نظرك بحديثه باللغة العربية المشوبة بالكلمات العامية ”القطيفية البحتة“، فلا تقول ”إن هذا هو هذا“، إذا لم يكن لديك سابق معرفة به، فهو مثقف من الطراز الأول، يتحدث بلغة علماء الدين الأوائل المتمكنّين من مادتهم العلمية، ويدهشك هذا الرجل المتواضع البصير «سبق ان فقد بصره وهو في مقتبل العمر» بما يملك من التجارب والمعلومات، فضلا عن الأدب، بالتالي فحياته قصة، وقصة حياته عبرة.
إنه الشاعر والوجيه والمحامي محمد سعيد بن الشيخ على أبو الحسن الخنيزي، الذي يعد قمة شامخة من شعراء الرعيل الأول الذين حفلت بهم القطيف، بل هو أول من أصدر ديوانا شعريا في المنطقة الشرقية، فهو بذلك قمة ثقافية وأدبية رائدة ذات قيمة مضافة إلى ما تتمتع به هذه المنطقة من نمو على مختلف الصعد.
وقديما قالوا، إن الرقي الحضاري، والنمو الثقافي، والوعي بشكل عام في أي منطقة يظهر في وجوه أبناء هذه المنطقة، ومنطق لسانهم، وطريقة تفكيرهم، ومن يتمعن أو يجلس مع الشاعر الخنيزي يقف أمام هذه الحقيقة الناصعة، فالبساطة، والنباهة، والتواضع، والريادية تتجلى في هذا الشخص، وإذا نطق أو تحدث أو كتب، تقف امام هذه الحقائق، لتنتقل من مرحلة ”الظن“ الحيادية، على مرحلة ”اليقين“ الثابتة، فتجد نفسك أمام شخصية ساهمت في بناء وتوجيه جيل «بل أجيال» من الشعراء والأدباء والمثقفين، وحظي بتكريم العديد من الجهات المعنية، كونه شاعرا قطيفيا بالأصالة، وسعوديا بالوطنية، وعربيا بالصوت والصورة والموهبة.
”ابن الشيخ“ تلك هي الصفة المحببة التي تحلو لمن داوم على اللقاء مع هذا الشاعر الفذ، رغم أن لديه عددا من الأولاد الذين ورثوا من والدهم الفضيلة وحب العلم والثقافة، والبعض يناديه باسم ابنه الأكبر ”ابوعلي“، لكن صفة ”ابن الشيخ“ غلبت عليه، وذلك في إشارة إلى والده الزعيم الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، الذي عمل قاضيا لفترة طويلة في القطيف، وكان مرجعا في الإرشاد التربوي والفقهي للإخوة السنة فضلا عن الشيعة، ولديه كتاب عن الوحدة بين المسلمين، عرف به، وهو «يرحمه الله» يحمل السمة العلمية الدينية، والروح الوحدوية، والتي تأثر بها أولاده وأبرزهم شاعرنا الذي التصقت به صفة ”ابن الشيخ“، يضاف له باقي أخوانه وبالتحديد الشيخ الراحل الشاعر والقاضي عبدالحميد الخطي «رحمه الله»، والشيخ القاضي السابق أيضا الشيخ عبدالله الخنيزي.
وكانت ولادة ابن الشيخ في فبراير 1925 «وقيل قبل ذلك بسنوات»، ويكون قد دخل عمر المائة، ولا شك أن هذه الفترة شهدت أحداثا اجتماعية وثقافية عديدة، عاصر فيها جملة من النقلات المحورية في التاريخ الحديث لبلادنا، لعل أبرزها انتقال بلادنا الحبيبة من مرحلة الضعف والفقر، إلى عالم الاقتصاد الرحب، والتنمية وخططها المفصلية، حيث الصناعة ووسائل النقل الحديثة، على عالم التقنية الحديث الذي نشهد تطوراته المذهلة يوميا، وشاعرنا كان حاضرا في كل هذه التطورات من شتى زواياها، خصوصا الزاوية الثقافية.
عدا أن النقطة الحاسمة في حياته أنه عاش المعاناة بأدق تفاصيلها، رغم اعترافه بأنه لم يحرم من حنان وحنو الأب والأم والخال «علي بن عبد الوهاب الغانم»، تجلّت هذه المعاناة وهو في سن السابعة من عمره تعرّض لإصابة بقيت معه طوال عمره المديد، إذ غاب نور بصره، التي وصفها ب ”الكارثة“، وذلك في لقاء صحفي أجراه معه الإعلامي فؤاد نصر الله، إذ يقول: ”ظللت أعيش جمال الطفولة، حتى اصبت بكارثة ممضة وهي إصابتي في عيني، والعين هي المرآة التي تنعكس عليها صور الحياة، فكانت لي بركانا متفجرا ونزيفا ينز جروحا انعكست في شكوى قصائد باكية كتبتها تخفيفا لهذا الألم الذي يتجدّد كلّما عطشت لأشرب من سلسال الحرف فأعود بحسرات ظامئة تنعكس شعرا متفجرا لهيبا في قصائد مأساوية تمثل الواقع المرير“.
لكن هذه الإصابة هل أقعدته، أو نالت من طموحه، رغم أنها جاءت مبكّرة، بل مبكّرة جدا، إذ من المتعارف أن فقدان البصر هو رفيق الكبار والمرضى، وليس للأطفال؟
إضافة إلى ما ذكر، فإن تلك الإصابة لم تنل منه شيئا، ولم تحرم البلاد والثقافة من كونه مشروعا مميزا يخدم البلاد، بل ظل خادما لهذه البلاد ولهذا المجتمع، ببصيرة نافذة وقدرات ذاتية مميزة.
بعد الإصابة، لم تشأ الإرادة الإلهية لـ ”ابن الشيخ“ أن يضيع، أو لينتهي كمشروع مميز كتب في صفحة القدر، بأن يكون شيئا ما مميزا، وأن يتحوّل هذا البصير الصغير إلى مشروع شاعر ومحام في الوقت نفسه، إذ تقول السيرة الذاتية التي أرّخها بشكل مفصل في كتابه ”خيوط من الشمس“، أنه في تلك الفترات، التحق مع كافة زملائه إلى الدراسة في الكتاتيب، الذي نطلق عليه في عرفنا بمحافظة القطيف ”المعلّم“، إذ يلتحق الأطفال بالدراسة عند من يقوم بهذه المهمة، فقد يكون ”المعلّم“ رجلا، وقد يكون إمراة، ويطلق عليها ”المعلّمة“ وكان نصيب ”ابن الشيخ“ وكان في كنف والده الشيخ علي أبوالحسن الخنيزي، الذي قام بتوجيهه نحو الكتّاب «او المعلم»، ولم تمنعه الإعاقة البصرية عن انتهال العلم فكان أول إنجازاته على هذا الصعيد هو حفظ القرآن، كمقرّر أول للدراسة في الكتاتيب، وذلك لدى الشيخ محمد بن صالح البريكي ثم أخيه الشيخ ميرزا البريكي، ورافق ذلك دراسة السيرة النبوية الشريفة، مع بعض الدروس في الحساب، ويسمى بالجمع والطرح والضَّرب والقسمة، والشِّعْرِ العربي.
وكان يرافقه في البدايات جملة من الطلاب الذين تحوّلوا بقدرة قادر إلى رموز للثقافة والأدب في محافظة القطيف، بل في البلاد بشكل عام مثل السيد علي بن باقر العوامي، والسيد حسن العوامي، وسليمان الفارس، ومنصور بن مهدي نصر الله، وعبدالواحد نصر الله وغيرهم.
بناء على ذلك، فإن شاعرنا ولد في ظروف ذاتية خاصة بها من المعاناة الشيء الكثير، لكنّه في الوقت نفسه عاش في بيئة تقدس العلم والثقافة الدينية بالتحديد، بحكم أن والده كما سبق القول رجل دين، مارس القضاء، وحمل صفة الوحدوية فكان يحكم للسنة والشيعة، وهذا ما انعكس على حياته في المراحل التالية، فهو يقدس العلم والثقافة وسار بهذه السيرة.
بعد تلك المرحلة التي كانت قاسية عليه، وهو في سن يافعة، لم يكن بمقدوره تجاوز المقدور، والخروج من دائرة القضاء الإلهي، فكان نصيبه أن يكون ”بصيرا“، فقد بلغ سن الثالثة عشرة من عمره، وقد تجاوز المراحل الدراسة الأولية في الكتاتيب، التي تتلاءم مع سنه الصغير، ليسير بسيرة والده، واتجه للتخصص في العلوم الدينية، وهذا التخصص يتطلب مواصفات ذاتية وعملية، لعل أبرزها الحضور الذهني الدائم، والتركيز فضلا عن الصفات الروحية الإيمانية التي هي ملازمة لهذا النوع من التخصص، وتكاد لا تنفك، فالمجتمع ينظر لطالب العلوم الدينية نظرة تصل إلى حد القداسة، ولا بد أن ينسجم العنوان على المعنون.
والدراسة في هذا التخصص تشمل النحو، والمنطق، والفقه وأصوله، واللغة والفلسفة والأخلاق فقرأ بعض كتب اللغة مثل ”متن الأجرومية“، و”قطر الندى وبل الصدى“ لابن هشام، وشرح ألفية ابن مالك لابن عقيل، و”مغنى اللبيب“ لابن هشام، كما قرأ بعض الكتب الفلسفية مثل الحاشية والشَّمسية في المنطق، وقرأ كُتُبَ البلاغة، كالمطوَّل، ومختصره. كما درس الفقه وأصوله.
وفي الحوار سابق الذكر مع الإعلامي فؤاد نصر الله ذكر الخنيزي أنه خلال هذه المسيرة كان والده الزعيم الشيخ على أبو الحسن الخنيزي المعلم الأول، ثم الشيخ فرج العمران، ثم الشيخ عبدالحميد الخطي «رحمهم الله جميعا»، وقد أتقن كل هذه العلوم وصار معلّما للطلبة الآخرين، وقد تربّى علي يديه عدد من الطلاب الذين صار لهم فيما بعد حضور دائم في سماء الثقافة بشكل عام، والثقافة الدينية بشكل خاص مؤثرين منهم: العلاَّمة الشَّيخ عبد الله الشَّيخ علي الخنيزيُّ، والشَّيخ عباس المحروس، وعبد الغني أحمد السنان، ومحمَّد سعيد الشَّيخ محمَّد علي بن حسن علي الخنيزي، ومهنَّا الحاج حسن الشَّماسي، وعضو مجلس الشورى سابقا محمَّد رضا نصر الله، وفؤاد عبد الواحد علي نصر الله، ومحمَّد وحسن ابنا الشَّيخ فرج العمران، وجاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسن آل خضر، وجمال عبد اللطيف، وحسن أحمد الطويل وغيرهم.
لم يتوقف مسلسل المعاناة لدى الشاعر الخنيزي إذ فقد والده، وهو يقارب العشرين من عمره، لكنّه بلغ مرحلة من النضج الثقافي جعلته يقرر مواجهة الحياة بكل عنفوان وإصرا ر، ولم يتوقف عن التحصيل العلمي، بل بلغ شأوا كبيرا في هذا المجال، ثم توجه للدخول في الحياة العملية، فعمل وهو على اعتاب سن العشرين في المحاماة، وكان قد برزت لديه الموهبة الشعرية بشكل كبير.
من هنا يمكن القول بأن شخصية ”ابن الشيخ“ صقلتها المعاناة أولا «فقد بصره، وفاة والده»، ثم التحصيل العلمي «الشرعي والأدبي»، فجعلت منه شاعرا مميزا يغلب عليه الطابع الرومانسي الحزين، وجعلته متعاطفا مع الآخرين لذلك بزغ نجمه في الحياة العملية كمحام، وأبرز شروط المحامي في تلك الفترة هي اتقانه للعلوم الشرعية، ومعرفته للقوانين، فضلا عن القدرات البلاغية التي تجعله يصيغ المرافعة القانونية، وهذا ما حصل عليه، فهو يملك موهبتي الكتابة والخطابة والجامع بينهما القدرة على نظم الكلام.
وقد التحق بالمحاماة منذ العام 1374 هـ واستمر بها حتى العام 1415، أي أكثر من 40 عاما، وكان مبرر اختياره لهذه المهنة هو حبه للخير والحق ونصرة المظلوم، وقد اختار هذه المهنة بنفسه دون فرض وبرضى نفسي منه، حتى أنه لم يخسر أي قضية، نتيجة التدقيق في الاختيار، ولم يتبن أي قضية ما لم يكن مقتنعا بسلامة الموقف.
رغم الظروف الصعبة، والانشغال بالحياة العملية، إلا أن ”ابن الشيخ“ لم يترك الشعر منذ أن اتقنه ومنذ نعومة أظفاره، ومن المؤكد أنه نظم الشعر في سن مبكرة، فقد صدر له أول ديوان وهو ”النغم الجريح“، عام 1961، ثم ديوان ”شيء اسمه الحب“ عام 1976، و”شمس بلا أفق“ عام 1986. ثم تتالت الإصدارات بين شعر ونثر حيث ألف: ”مدينة الدراري“، ”كانوا على الدرب“، ”خيوط من الشمس“، ”تهاويل عبقر“، ”العبقري المغمور“، ”أضواء من النقد في الأدب العربي“، ”إيحاءات سماوية“، ”أوراق متناثرة“، ”أشباح في الظلام“، ”من ذاكرة التاريخ“، ”أيام من الماضي“، ”المعري الشاك“، ”ذكرى أبو نسيم“، ”دراسات في شعر أبي نواس“، ”أطياف وراء السديم“، ”من قراءات الكتب“، ”تأملات“، ”أحداث تاريخية“، ”من جراحات الأيام“.
وقد نشر قصائده ومقالاته في العديد من الصحف والمجلات المحلية والعربية، ومنها: ”الكتاب“ في مصر، و”الأديب“ و”العرفان“ و”الألواح“ و”المعارف“، في لبنان، و”الغري“ و”الأفق“ في العراق، و”الرائد“ و”العربي“ في الكويت، أخبار الظهران، وصوت البحرين، وعدد من الصحف السعودية والخليجية، كما أذيعت بعض قصائده في عدد من الإذاعات السعودية والخليجية والعربية، بالإضافة لإذاعة ال BBC، الواسعة الانتشار.
وقد كتب عنه مؤرخون ونقاد من مختلف الاتجاهات، منهم: عبد الرحمن العبيد، والشيخ عبد الله الخنيزي، والشيخ عبد الهادي الفضلي، وسعود الفرج، وعبد الله السبيعي، وعبدالله الحامد، بالإضافة إلى خليل الفزيع، وفؤاد نصر الله.
إن هذه الموهبة، وهذا العطاء هو نتاج موهبة تأصلت لدى هذا الرجل المتميز، نتيجة ظروف جاءت من البيئة الاجتماعية التي عاشها الشاعر «فضلا عن البيئة الأسرية والعلمية» كان لها مساهمة في تعميق الموهبة وتبادل التجربة في الشعر، فقد التحق بصالون أدبي اطلق عليه اسم ”النادي السيّار“ ضمن كوكبة من الأدباء والشعراء من محافظة القطيف منهم: المؤرخ محمد سعيد المسلم، والسيد على العوامي، واخوه السيد حسن العوامي، والشاعر عبدالواحد الخنيزي، والشاعر الشيخ عبدالله الخنيزي، والشاعر محمد سعيد الجشي وغيرهم، ففي هذا الصالون يتم اللقاءات وتبادل التجارب والقراءات والتقييمات للحالة الأدبية في القطيف، وقد تحدّث عن هذا الصالون في 40 صفحة من كتابه ”خيوط من الشمس“، وكان لهذا الصالون الذي شبهه بالرابطة القلمية للشعراء المهاجرين في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، تأثير كبير على عطاء الشاعر، وكان يشهد معارك أدبية تصل إلى درجة الحدية والصدام المباشر.
وإذا توقفنا قليلا عند الجانب الأدبي لدى هذا الرجل البصير نجد تفصيلا كثيرا، إذ ماذا نتوقع من شخص يملك موهبة شعرية ويمر بمثل هذه الظروف، ويخضع لهذه التربية المميزة، فلا بد أن يكون شعره ذا سمات خاصة لها علاقة بالبيئة التي عاشها من جانبها السلبي أو الإيجابي، إذ يورد كل من قرأ شعره على هذه النقطة التي تظهر في المواصفات التالية:
1/ يرد في شعره حالة الحزن، نتيجة ”الغربة“ التي عاشها وهو في وطنه، فمن يفقد البصر يعيش نوعا من الغربة عن الآخرين، وربما شعر أنه مختلف عن أقرانه، لذلك جاء شعره مليئا بلمسات حزن واضحة وصريحة، متأثرا في ذلك بمن عاشوا الظروف نفسها مثل البردوني، وابي العلاء المعري، فضلا شعراء المهجر الذين كانوا يبثون احزانهم للطبيعة والتغزل بها نظير شوقهم لبلادهم الأصلية ومساقط رأسهم:
ففي قصيدة ”الآهاتُ المجرَّحة“ يقول الخنيزي:
متُّ يا ربِّ قبلَ يوم مماتي!
ودفنتُ الأوتارَ في الأهاتِ
آهةٌ إثْر آهةٍ.. تتنزَّى!
من ليالي الأحداثِ والنَّكبات
زفراتٌ أطلقتُها من فؤادٍ
ذابَ منها الفؤادُ في الزفرات
وسكبتُ الفؤاد في الكأْس دمعاً
فتلظتْ في الكفِّ كالجمرات
إلى أن يقول:
وكتبتُ الغرام مقْطعَ شِعْرٍ
جسَّدتْهُ الحروفُ في الكلمات
وطويتُ القلاعَ للشاطِيءِ المهْ
جُورِ. مثلَ الشُّعاع في الرَّبوات
وأخذتُ المكان في الصخرةِ البي
ضاِء.. أُلقِي على الدُّنى نظراتي
صدمتْكَ الحياةُ في العين.. والأعـ
ـينُ سرُّ الحياة في الكائنات
يبدو الهم والحزن والأسى، ماثلا لا تخطئه العين، ولا يحتاج إلى تأويل، يكفي أنه في البيت الأخير يتحسر على فقدانه نور البصر، وكانت صدمة، ولكن أي صدمة، صدمة استمرت أكثر من تسعين عاما.
2/ إن النبرة الحزينة التي طالت شعر الخنيزي، لم تخرجه عن أن يتعامل مع الحياة بواقعية والإيمان بالقدر خيره وشرّه، ولم يدخله في ”شرنقة“ اليأس على غرار ما جرى لغيره ممن عاشوا الظروف ذاته «المعرّي مثلا»، وربما لأصالة التربية الدينية والدراسة للعلوم الشرعية التي تزوّد بها منذ نعومة أظفاره، جعلته يسير ضمن هذا الإطار، «القلب يحزن، والعين تدمع، ولا نقول الا ما يرضي الرب»
يقول الخنيزي في إحدى قصائده:
إذا ما أطلَّ الظلام الكئيب ومرَّ بجفنيكِ طيف الحبيبْ
ولاحت لعينيكِ دنيا الشباب.. ترفُّ على عالمٍ من لهيب!
وشاهدتِ حلم الشباب الفتيّ يموت وراء ضباب المشيب!
فلا تسكبي الدمع يا فتنتي. ولا تجزعي من ظلال الغروب!
والعبارات واضحة، والمعنى واضح، الحزن يسيطر وهذه طبيعة الحياة، ولكن ثمة فسحة من أمل موجودة ينبغي التوجه لها، ولتكن الحوادث مصدرا للعبرة والتذكرة وتعميق الإيمان
وعلى ذات النسق يقول:
إذا ما رأيتِ طيوف الشجونِ.. تَراقصُ حولك مثل الظلام
تمرُّ بنعش الحياة الرهيبِ.. فتُودِع أشلاءها في الرَّغام
وتنسج في جوِّك الحادثات. حياةً ملبَّدةً... بالغمام
فلا تسكبي الدمع - يا فتنتي - ولا تجزعي من خيال الحِمام
يقول الخنيزي:
إذا ما رأيتِ جُذى الذكريات. رماداً، ذَرَتْه رياح القدرْ
لتجبل منه السنون الكؤوس. فترتدُّ صارخة بالبشر:
هلمَّ اشربوا من مَعين الحياة. كؤوساً تفيض بشتى العِبَر
فهو يرى أن الذكريات «فقد تكون مؤلمة»، لكنّها في الوقت نفسه تقدم للإنسان هدايا مقابل ذلك الألم جملة من التجارب والعبر، ومن يتبنّى مثل هذا التوجه لا بد وأن حالة عميقة من الإيمان والتفاؤل قد تعمقت في داخله، إنها دعوة للحياة، ومقاومة الظروف التي لا تكون دائما في صالح الإنسان.
3/ يؤكد الشاعر نفسه في لقاءاته الخاصة بأنه اطلع على الشعراء العراقيين مثل الزهاوي والرصافي، ولم يكن بعيدا عن شعراء المهجر، ويظهر ذلك بأن يلجأ لوصف الطبيعة التي تتحدث في شعره لتقول للبشر إن الحياة جميلة، ذلك على غرار ما ذهب إليه إيليا ابوماضي حينما قال ”كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسما والأنجم“، نجد هذا التوجه بارزا في شعر محمد سعيد الخنيزي منه على سبيل المثال:
وكن نسمةً كحنان الربيع. تضمِّد - عطفاً - جراح البشر
وكن جدولاً يملأ الخافقين. فيسقي القلوب ويسقي الفكر
وكن مشرقاً، مثل بدر السماء. يضيء الحياة: شعاعاً أغر...!
ومثل ذلك:
كأنَّ غدي موجة من ظلامٍ. يقهقه من حاضري الساخر
فإن الحياة كدنيا القبور. متى عُرِّيت من رجى ناضر
فكن أملاً أخضراً كالربيع فتورق دنيا، كدنيا الزهرْ
في ختام هذه الوقفة مع الشاعر محمد سعيد علي أبو الحسن الخنيزي لا بد من التنويه بأننا وخلال السطور الماضية اشرنا «باختصار» إلى بعض الملاحظات العامة، ولم ندخل التفاصيل، لأنها طويلة «عمرها مائة عام»، والأسئلة عديدة «وهي مشروعة بالطبع»، والسيرة عطرة بها صور من الحالة العصامية المتمثلة في تحدّي الإعاقة «حسب المصطلح»، وتجاوزها رغم ألمها ومن ثم الإبداع في الحياة العملية والعلمية والأدبية، هذا فضلا عن الإنجاز الأهم الذي حققه هذه الرجل وهو رفد المجتمع بجملة من المؤلفات الرائعة في الشعر والنقد، وقيامه بدور رائع ترفع له القبّعات في تربية عدد من الأولاد والبنات هم «وهنّ» جميعا مفخرة هذا الرجل، ومفخرة هذه البلاد.
تلك وقفة مختصرة مع الشاعر المتألق محمد سعيد بن على أبو الحسن الخنيزي.